كان التأويل في استعمال السلف مترادفا مع التفسير، وقد دأب عليه أبو جعفر الطبري في جامع البيان لكنه في مصطلح المتأخرين جاء متغايرا مع التفسير، وربما اخص منه.
التفسير رفع الإبهام عن اللفظ المشكل، فمورده: إبهام المعنى بسبب تعقيد1حاصل في اللفظ.
وأما التأويل فهو دفع الشبهة عن المتشابه من الأقوال والأفعال، فمورده حصول شبهة في قول أو عمل، أوجبت خفاء الحقيقة (الهدف الأقصى او المعنى المراد) فالتأويل إزاحة هذا الخفاء.
فالتأويل مضافا إلى انه رفع إبهام فهو دفع شبهة أيض، فحيث كان تشابه في اللفظ كان إبهام في وجه المعنى أيض، فهو دفع ورفع معاً.
ولنتكلم شيئاً في التأويل، في حقيقته والمعاني التي جاء استعمالها في القرآن والحديث، وما قيل أو قد يقال فيه.
التأويل: من الأول، وهو الرجوع إلى حيث المبد، فتأويل الشيء إرجاعه إلى أصله وحقيقته، فكان تأويل المتشابه توجيه ظاهره إلى حيث مستقر واقعه الأصيل.
والتشابه قد يكون في كلام إذا أوجب ظاهر تعبيره شبهة في نفس السامع، أو كان مثاراً للشبهة، – كما في متشابهات القرآن -، كان يتبعها أهل الزيغ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى حيث أهدافهم الخبيثة.
و قد يكون التشابه في عمل كان ظاهره مريب، كما في أعمال قام بها صاحب موسى، بحيث لم يستطع موسى الصبر عليها دون استجوابه، والسؤال عن تصرفاته تلك المريبة.
والآن فلنذكر المعاني التي يحملها لفظ “التأويل” في عرف القرآن واستعمال السلف.
معاني التاويل
جاء استعمال لفظ “التاويل” في القرآن على ثلاثة وجوه
1- تاويل المتشابه، بمعنى توجيهه حيث يصح ويقبله العقل والنقل، اما في متشابه القول، كما في قوله تعالى : ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ﴾2، او في متشابه الفعل، كما في قوله: ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾، ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾3.
2- تعبير الرؤي، وقد جاء مكرراً في سورة يوسف في ثمانية مواضع: (6-21-36-37-44 -45-100-101)
3- مآل الأمر وعاقبته، وما ينتهى اليه الأمر في نهاية المطاف، قال تعالى: ﴿وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾4، أي أَعْود نفعاً وأحسن عاقبة.
ولعل منه قوله: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾5، أي أنتج فائدة وأفضل مآلاً.
ويحتمل أوجه تفسيراً وأتقن تخريجاً للمعنى المراد، نظير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾6، وقال تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾7، أي هل ينتظرون ماذا يؤول اليه أمر الشريعة والقرآن، لكن لا يطول بهم الإنتظار﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ﴾8، ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ﴾9، ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾10.
4- والمعنى الرابع – للتاويل – جاء إستعماله في كلام السلف: مفهوم عام، منتزع من فحوى الآية الواردة بشأن خاص، حيث العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد.
وقد عبر عنه بالبطن المنطوي عليه دلالة الآية في واقع المراد، في مقابلة الظهر المدلول عليه بالوضع والإستعمال، حسب ظاهر الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: “ما في القرآن آية الا ولها ظهر وبطن“.
سئل الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام عن هذا الحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: “ظهره تنزيله وبطنه تأويله، منه ما قد مضى ومنه ما لم يكن، يجري كما تجري الشمس والقمر“11.
وقال عليه السلام: “ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم، ماتت الآية ولما بقي من القرآن شي ولكن القرآن يجري أوله على آخره، ما دامت السماوات والأرض، ولكل قوم آية يتلونه، هم منها من خير أو شر“12.
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: “ان فيكم من يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله، وهو على بن ابي طالب“13.
فإنه صلى الله عليه وآله قاتل على تنزيل القرآن، حيث كان ينزل بشأن قريش ومشركي العرب ممن عاند الحق وعارض ظهور الإسلام أما علي عليه السلام فقد قاتل أشباه القوم ممن عارضوا بقاء الإسلام، على نمط معارضة أسلافهم في البدء.
ولهذا المعنى عرض عريض، ولعله هو الكافل لشمول القرآن وعمومه لكل الأزمان والأحيان، فلولا تلك المفاهيم العامة المنتزعة من موارد خاصة -وردت الآية بشأنها بالذات – لما بقيت لأكثر الآيات كثير فائدة، سوى تلاوتها وترتيلها ليل نهار.
وإليك بعض الأمثلة على ذلك
مفاهيم عامة منتزعة من الآيات
قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾14.
نزلت بشان غنائم بدر، وغاية ما هناك أن عمت غنائم جميع الحروب، على شرائطها.
لكن الإمام أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام نراه يأخذ بعموم الموصول، ويفسر “الغنيمة” بمطلق الفائدة، وأرباح المكاسب والتجارات، يربحها أرباب الصناعات والتجارات وغيرهم طول عامهم، في كل سنة بشكل عام.
قال عليه السلام: “فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال اللّه تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾.
وهكذا عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: “الخمس في كل ما افاد الناس من قليل او كثير”15.
وقال تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾16.
نزلت بشان الإعداد للجهاد، دفاعاً عن حريم الاسلام، فكان مفروضا على أصحاب الثروات القيام بنفقات الجهاد، دون سيطرة العدو الذي لا يبقي ولا يذر.
لكن “السبيل” لا يعني القتال فحسب، فهو يعم سبيل إعلاء كلمة الدين وتحكيم كلمة الله في الأرض، ويتلخص في تثبيت أركان الحكم الإسلامي في البلاد، في جميع ابعاده: الإداري والإجتماعي والتربوي والسياسي والعسكري، وما شابه وهذا انما يقوم بالمال، حيث المال طاقة يمكن تبديلها الى اى طاقة شئت، ومن ثم قالوا: قوام الملك بالمال فالدولة القائمة بذاتها إنما تكون قائمة اذا كانت تملك الثروة اللازمة لإدارة البلاد في جميع مناحيها.
وهذا المال يجب توفره على أيدي العائشين تحت لواء الدولة الحاكمة، ويكون مفروضاً عليهم دفع الضرائب والجبايات، كل حسب مكنته وثروته، الأمر الذي يكون شيئاً وراء الأخماس والزكوات التي لها مصارف خاصة، لا تعني شؤون الدولة فحسب.
وهذه هي (المالية) التي يكون تقديرها وتوزيعها على الأموال والممتلكات، حسب حاجة الدولة وتقديره، ومن ثم لم يتعين جانب تقديرها في الشريعة، على خلاف الزكوات والاخماس، حيث تعين المقدار والمصرف والمورد فيها بالنص.
فقد فرض الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق في كل فرس في كل عام دينارين، وعلى البراذين ديناراً17.
ضابطة التأويل
ومما يجدر التنبه له ان للأخذ بدلائل الكلام – سواء اكانت جلية ام خفية – شرائط ومعايير، لا بد من مراعاتها للحصول على الفهم الدقيق فكما ان لتفسير الكلام – وهو الكشف عن المعاني الظاهرية للقرآن – قواعد وأصول مقررة في علم الأصول والمنطق، كذلك كانت لتأويل الكلام وهو الحصول على المعاني الباطنية للقرآن – شرائط ومعايير، لا ينبغي اعفاؤها والا كان تأويلاً بغير مقياس، بل كان من التفسير بالرأي الممقوت.
وليعلم أن التأويل – وهو من الدلالات الباطنية للكلام – داخل في قسم الدلالات الإلزامية غير البينة، فهو من دلالة الألفاظ لكنها غير البينة، ودلالة الألفاظ جميعاً مبتنية على معايير يشرحها علم الميزان، فكان التأويل – وهو دلالة باطنة – بحاجة إلى معيار معروف كي يخرجه عن كونه تفسيراً بالرأي.
فمن شرائط التأويل الصحيح – اي التأويل المقبول في مقابلة التأويل المرفوض – أولاً: رعاية المناسبة القريبة بين ظهر الكلام وبطنه، أي بين الدلالة الظاهرية وهذه الدلالة الباطنية للكلام، فلا تكون أجنبية، لا مناسبة بينها وبين اللفظ أبدا فإذا كان التأويل – كما عرفناه – هو المفهوم العام المنتزع من فحوى الكلام، كان لا بد أن هناك مناسبة لفظية أو معنوية استدعت هذا الانتزاع.
مثلا: لفظة “الميزان” وضعت لآلة الوزن المعروفة ذات الكفتين، وقد جاء الأمر بإقامتها وعدم البخس فيه، في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَان﴾18.
لكنا إذا جردنا اللفظ من قرائن الوضع وغيره واخلصناه من ملابسات الأنس الذهني، فقد أخذنا بمفهومه العام: كل ما يوزن به الشي، اي شي كان مادياً ام معنوي، فإنه يشمل كل مقياس او معيار كان يقاس به او يوزن به في جميع شؤون الحياة، ولا يختص بهذه الآلة المادية فحسب.
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي: فالميزان آلة التعديل في النقصان والرجحان، والوزن يعدل في ذلك ولولا الميزان لتعذر الوصول الى كثير من الحقوق، فلذلك نبه تعالى على النعمة فيه والهداية إليه وقيل: المراد بالميزان: العدل، لان المعادلة موازنة الاسباب19.
وروى محمد بن العباس المعروف بماهيار (ت ح330 ) – في كتابه الذي وضعه لبيان تأويل الآيات – بإسناده الى الإمام الصادق عليه السلام قال: الميزان الذي وضعه الله للأنام، هو الإمام العادل الذي يحكم بالعدل، وبالعدل تقوم السماوات والأرض، وقد أمر الناس أن لا يطغوا عليه ويطيعوه بالقسط والعدل، ولايبخسوا من حقه، أو يتوانوا في إمتثال أوامره20.
وهكذا قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَّعِينٍ﴾21. كانت دلالة الاية في ظاهر تعبيرها واضحة، إن نعمة الوجود ووسائل العيش والتداوم في الحياة، كلها مرهونة بإرادته تعالى وفق تدبيره الشامل لكافة أنحاء الوجود.
والله تعالى هو الذي مهد هذه البسيطة لا مكان الحياة عليه، ولولا فضل اللّه ورحمته لعباده لضاقت عليهم الأرض بما رحبت.
هذا هو ظاهر الآية الكريمة، حسب دلالة الوضع والمتفاهم العام.
وللإمام ابي جعفر الباقر عليه السلام بيان يمس جانب باطن الآية ودلالة فحواها العام، قال: “اذا فقدتم امامكم فلم تروه فماذا تصنعون“.
و قال الإمام على الرضا عليه السلام: “ماؤكم: أبوابكم الأئمة، والأئمة: أبواب الله فمن يأتيكم بماء معين، أي يأتيكم بعلم الامام“22.
لا شك أن استعارة (الماء المعين) للعلم النافع، ولا سيما المستند إلى وحي السماء – من نبي او وصي نبي – أمر معروف ومتناسب لا غبار عليه.
فكما ان الماء أصل الحياة المادية والمنشأ الأول لإمكان المعيشة على الارض، كذلك العلم النافع وعلم الشريعة بالذات، هو الأساس لا مكان الحياة المعنوية التي هي سعادة الوجود والبقاء مع الخلود.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾23.
﴿لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ﴾24.
فهنا قد لوحظ الماء – وهو أصل الحياة – في مفهومه العام المنتزع منه الشامل للعلم، فيعم الحياة المادية والمعنوية.
وأيضاً قوله تعالى: ﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾25، اي فليمعن النظر في طعامه، كيف عملت الطبيعة في تهيئته وتمهيد إمكان الحصول عليه، ولم يأته عفو، ومن غير سابقة مقدمات وتمهيدات لو أمعن النظر فيه، لعرف مقدار فضله تعالى عليه، ولطفه ورحمته، وبذلك يكون تناول الطعام له سائغ، ومستدعياً للقيام بالشكر الواجب.
هذ، وقد روى ثقة الاسلام الكليني باسناده الى زيد الشحام، قال: سألت الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قلت: ما طعامه؟ قال: “علمه الذي يأخذه عمن يأخذه“26.
والمناسبة هنا – أيضا – ظاهرة، لأن العلم غذاء الروح، ولا بد من الاحتياط في الأخذ من منابعه الأصيلة، ولاسيما علم الشريعة وأحكام الدين الحنيف.
وثانياً: مراعاة النظم والدقة في إلغاء الخصوصيات المكتنفة بالكلام، ليخلص صفوه ويجلو لبابه في مفهومه العام، الأمر الذي يكفله قانون (السبر والتقسيم) من قوانين علم الميزان (علم المنطق) والمعبر عنه في علم الأصول: بتنقيح المناط، الذي يستعمله الفقهاء للوقوف على الملاك القطعي لحكم شرعي، ليدور التكليف او الوضع معه نفياً وإثبات، ولتكون العبرة بعموم الفحوى المستفاد، لا بخصوص العنوان الوارد في لسان الدليل وهذا أمر معروف في الفقه، وله شرائط معروفة.
ومثال تطبيقه على معنى قرآني، قوله تعالى – حكاية عن موسى عليه السلام- : ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ﴾27.
هذه قولة نبي الله موسى عليه السلام قالها تعهداً منه لله تعالى، تجاه ما أنعم عليه من البسطة في العلم والجسم: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾28 قضى على عدوله بوكزة وكزه به، فحسب إنه قد فرط منه ما لا ينبغي له، فاستغفر ربه فغفر له فقال ذلك تعهداً منه لله، أن لا يستخدم قواه وقدره الذاتية، والتي منحه الله به، في سبيل الفساد في الأرض، ولا يجعل ما آتاه الله من إمكانات معنوية ومادية في خدمة أهل الإجرام.
هذا ما يخص الآية في ظاهر تعبيرها بالذات.
وهل هذا أمر يخص موسى عليه السلام لكونه نبياً ومن الصالحين، أم هو حكم عقلي بات يشمل عامة أصحاب القدرات، من علماء وأدباء وحكماء وأرباب صنائع وفنون، وكل من آتاه الله العلم والحكمة وفصل الخطاب؟ لا ينبغي في شريعة العقل أن يجعل ذلك ذريعة سهلة في متناول أهل العبث والاستكبار في الأرض، بل يجعلها وسيلة ناجحة في سبيل إسعاد العباد وإحياء البلاد ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾29.
وهذا الفحوى العام للآية الكريمة إنما يعرف وفق قانون (السبر والتقسيم) وإلغاء الخصوصيات المكتنفة بالموضوع، فيتنقح ملاك الحكم العام.
وفي القرآن كثير من هذا القبيل، إنما الشأن في إمعان النظر و التدبر في الذكر الحكيم، وبذلك يبدو وجه استفادة فرض الأخماس من آية الغنيمة، ودفع الضرائب من آية الإنفاق في سبيل الله.
*التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، الشيخ محمد هادي معرفة، الجامعة الرضوية للجامعة الإسلامية، ط1، ص18-29.
1- وللتعقيد أسباب لفظية ومعنوية مر شرحها.
2- آل عمران: 7.
3- الكهف: 78، 82.
4- الإسراء: 35.
5- النساء: 59.
6- النساء: 83.
7- الأعراف: 53.
8- الفرقان: 22.
9- الأحقاف: 35.
10- ص: 3.
11- بصائر الدرجات، الصفار، ص 195.
12- تفسير العياشي، ج1، ص10، رقم7.
13- المصدر نفسه، ص15، رقم6.
14- الأنفال: 41.
15- وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج6، ص350، كتاب الخمس، باب 8، رقم 5-6.
16- البقرة: 195.
17- الوسائل، ج6، ص51.
18- الرحمن: 9.
19- التبيان، ج9، ص463.
20- نقلاً بالمعنى، راجع: تأويل الآيات الظاهرة للسيد شرف الدين الاسترابادي، ج2، ص 632-633.
21- الملك: 30.
22- تفسير الصافي، الفيض الكاشاني، ج2، ص 727، وراجع: تأويل الآيات الظاهرة، ج2، ص 708.
23- الأنفال: 24.
24- آل عمران: 164.
25- عبس: 24.
26- تفسير البرهان، ج4، ص 429.
27- القصص: 17.
28- القصص: 14.
29- هود: 61.
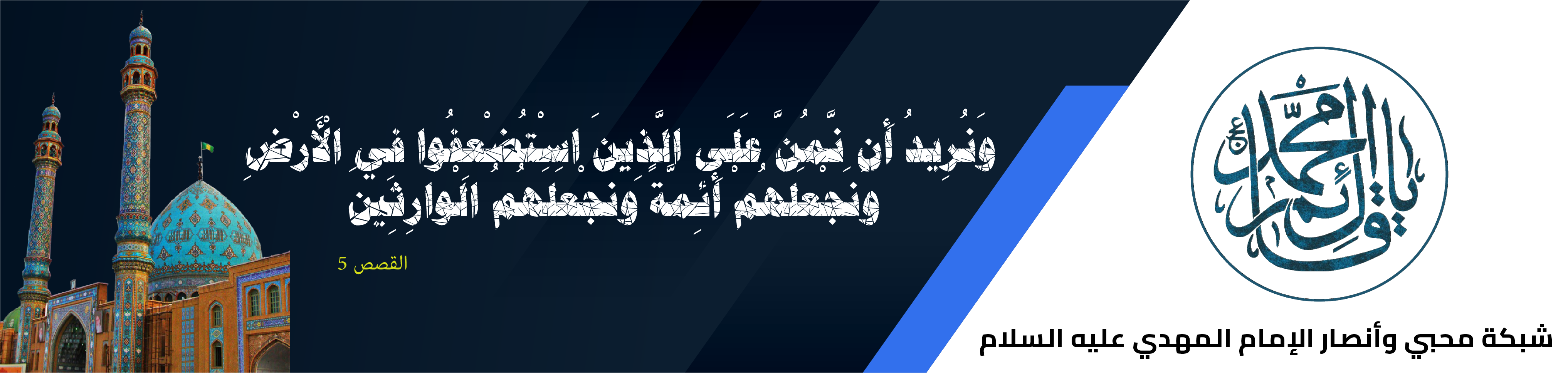 شبكة محبي وأنصار الإمام المهدي ع موقع اسلامي تربوي هادف منذ 1999
شبكة محبي وأنصار الإمام المهدي ع موقع اسلامي تربوي هادف منذ 1999