قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ﴾1.
قال في الإتقان: إنها منسوخة بقوله تعالى ﴿وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً﴾2.
وقال العتائقي: إنها منسوخة بقوله ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾3.
وعبر الزرقاني في المناهل عن ذلك بلفظ “قيل”.
ونجد في قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ فيها، وأنها من المحكمات، ولم يعدها النعماني من المنسوخ المنقول عن علي. وعدم النسخ محكي عن عطاء4، وبه قال الزرقاني في المناهل، والإمام الخوئي في تفسير البيان.
وقال الطبرسي بعد نقله النسخ عن قتادة وغيره: إن تحريم القتال في أشهر الحرم وعند المسجد الحرام باق عندنا على التحريم فيمن يرى لهذه الأشهر حرمة، ولا يبتدئون فيها القتال، وكذلك في الحرم. وإنما أباح الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله قتال أهل مكة عام الفتح، فقال صلى الله عليه وآله: إن الله أحلها لي في هذه الساعة، ولم يحلها لأحد من بعدي إلى يوم القيامة5.
ثم إن التأمل في هذه الآية يعطي أنها محكمة غير منسوخة، فإنها قررت تحريم القتال في الشهر الحرام، حين ورد فيها قوله تعالى ” قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله ” ولكن لو كان القتال جزاء لما هو أعظم وأشد منه لم يكن فيه بأس. ويستفاد من الآية أنها وقعت عن سؤال حول قضية حدثت آنذاك، ولعلها هي ما في تفسير البرهان في بيان هذه الآية: عن علي بن إبراهيم: أنه كان سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة بعث السرايا إلى الطرقات التي تدخل مكة، يتعرض بعير قريش، حتى بعث عبد الله بن جحش في نفر من الصحابة إلى النخلة – إلى أن قال: – وقد نزلت العير وفيهم عمرو بن عبد الله الحضرمي، وكان حليفا لعتبة بن ربيعة، فقال ابن الحضرمي: هؤلاء قوم عباد ليس علينا منهم بأس، فلما اطمأنوا ووضعوا السلاح حمل عليهم عبد الله بن جحش فقتل ابن الحضرمي وقتل أصحابه، وأخذوا العير بما فيها وساقوها إلى المدينة. فكان ذلك أول يوم من رجب من أشهر الحرم، فعزلوا العير وما كان عليها، ولم ينالوا منها شيئا.
فكتبت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك استحللت الشهر الحرام، وسفكت فيه الدم، وأخذت المال. وكثر القول في هذا، وجاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا رسول الله، أيحل القتل في الشهر الحرام؟ فأنزل الله ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ الآية.
فتحصل: أن القتال الذي وقع في الشهر الحرام بإذن النبي صلى الله عليه وآله لا يدل على نسخ حرمة القتال فيه، لأنه إنما كان جزاء لما هو أعظم وأشد.
هذا بالإضافة إلى أن صدر الآية – وهو قوله: ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ...الخ﴾ – يأبى عن النسخ، إذ كيف ينسخ أمر كبير فيه صد وكفر؟! وكيف يصح تجويز أمر كهذا؟! إلا أن يكون عقابا لهم على ذنب أعظم وأشد، وهذا الذنب قد أشير إليه في ذيل الآية، حيث قال ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ﴾ الآية.
وأما قوله تعالى ﴿وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً﴾ فهو وإن كان له عموم زماني بمقتضى إطلاقه فيشمل الشهر الحرام بالإطلاق إلا أن النهي الصريح عن القتال فيه يقيد هذا العموم، ويكون وجوب قتال المشركين مختصا بغير الأشهر الحرم. ويؤيد ذلك الإجماع المنقول عن الطبرسي على أن التحريم باق إلى الآن، وقد سبق.
وقال العلامة الحلي: كان الغرض في عهد النبي صلى الله عليه وآله الجهاد في زمان ومكان دون آخر، أما الزمان فإنه كان جائزا في جميع السنة، إلا في الأشهر الحرم – وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم – لقوله تعالى ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾. – إلى أن قال: – إذا عرفت هذا فإن أصحابنا قالوا: إن تحريم القتال في أشهر الحرم باق إلى الآن لم ينسخ في حق من يرى لأشهر الحرم حرمة، وأما من لا يرى لها حرمة فإنه يجوز قتاله فيها. وذهب جماعة من الجمهور إلى أنهما منسوختان بقوله ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾6.
ثم إن القول بنسخ تحريم القتال – كما حكيناه عن العتائقي ونسب إلى النحاس – غريب وعجيب، ولعله كان غفلة وسهوا منهم، فإن قوله تعالى ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ قد علق الحكم فيه على قوله ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ فكيف يكون ناسخا؟!
قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾7.
ذكر في الإتقان: أنها منسوخة بآيتين فـ﴿مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْل﴾ منسوخ بآية ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾8.
والوصية منسوخة بقوله ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾9.
وفي تفسير النعماني عن علي عليه السلام: أن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة، وكانت إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا، بعرة أو ما يجري مجراها، وقالت: البعل أهون إلي من هذه، ولا أكتحل ولا أتمشط ولا أطيب ولا أتزوج سنة، فأنزل الله تعالى في الإسلام: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾فلما قوي الإسلام أنزل الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...الخ﴾.
وممن قال بالنسخ هنا العتائقي قال: وليس في كتاب الله آية تقدم ناسخها على منسوخها في النظم إلا هذه الآية.
وكذا الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، وقال: اتفق العلماء على أن هذه الآية منسوخة.
وقال الزرقاني في مناهل العرفان: والحق هو القول بالنسخ، وعليه جمهور العلماء.
ثم قال: إن البعض يقول: إن الآية محكمة، ولا منافاة بينها وبين الثانية، لأن الأولى خاصة فيما إذا كان هناك وصية للزوجة بذلك ولم تخرج ولم تتزوج، أما الثانية ففي بيان العدة والمدة التي يجب عليها أن تمكثها، وهما مقامان مختلفان.
والذي يبدو لنا هو أن ما يظهر من الآيتين موافق لما نقله الزرقاني عن بعض، من أنهما تتضمنان لحكمين مختلفين، الأول: بيان وظيفة الأزواج بالنسبة لزوجاتهم بأن يوصوا لهن. والثاني: بيان وظيفة الزوجات أنفسهن بالنسبة إلى العدة، وأنه يجب عليهن التربص أربعة أشهر وعشرا، ولا تنافي بين هذين الحكمين، فلا وجه للنسخ.
ولكننا مع ذلك نجد أن الطبرسي قد نقل اتفاق العلماء على أن آية الوصية منسوخة بآية التربص، والزرقاني نقل اتفاق جمهور العلماء على ذلك.
ونجد أيضا عدة روايات تدل على وقوع النسخ في الآيتين، ونحن نذكر على سبيل المثال
1- ما تقدم عن تفسير النعماني عن علي عليه السلام.
2- ما رواه السيد هاشم البحراني عن العياشي عن معاوية بن عمار قال: سألته عن قول الله ” والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ” قال: منسوخة، نسختها آية﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ونسختها آية الميراث.
3- عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ قال: هي منسوخة، قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا، ثم أخرجت بلا ميراث. ثم نسختها آية الربع والثمن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها10.
إذا، فالنسخ ثابت بالإجماع والأخبار، ولعل ثبوته ووضوحه هو الموجب لعدم ذكر الإمام الخوئي لهذه الآية في جملة المنسوخات، وذلك لأنه قال في أول البحث: نحن نذكر الآيات التي كان في معرفة وقوع النسخ فيه وعدم وقوعه غموض في الجملة.
وكيف كان، فإن النسخ ثابت، ولم يخالف فيه أحد ظاهرا إلا الشافعي على ما في تفسير الجلالين، وقال السيوطي فيه: السكنى ثابتة عند الشافعي ولم تنسخ.
قوله تعالى ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ﴾11.
قال في الإتقان: إنها منسوخة بقوله بعده ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾12.
وقال العتائقي: فشق نزولها ﴿إِن تُبْدُوا…الآية﴾ عليهم، ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾، والمنسوخ قوله: ﴿أَوْ تُخْفُوه﴾.
ولكن لم يعد تفسير النعماني هذه الآية من المنسوخات فيما نقله عن علي، وكذلك فإن الإمام الخوئي لم يتعرض لها، وكأنه لا يراها من الآيات المنسوخة.
وقال في مناهل العرفان: والذي يظهر لنا أن الآية الثانية مخصصة للأولى، وليست ناسخة، فكان مضمونها: أن الله تعالى كلف عباده بما يستطيعون مما أبدوا في أنفسهم أو أخفوا، لا تزال هذه الإفادة باقية، وهذا لا يعارض الآية الثانية، حتى يكون ثمة نسخ.
وفي مجمع البيان للطبرسي قال: قال قوم: إن هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ ورووا في ذلك خبرا ضعيفا، وهذا لا يصح، لأن تكليف ما ليس في الوسع غير جائز، فكيف ينسخ؟ وإنما المراد بالآية ما يتناوله الأمر والنهي من الاعتقادات والإرادات.
وغير ذلك مما هو مستور عنا – إلى أن قال: – فعلى هذا يجوز أن تكون الآية الثانية مبينة للأولى، وإزالة توهم من صرف ذلك إلى غير وجهه، وظن أن ما يخطر بالبال أن تتحدث به النفس مما لا يتعلق بالتكليف فإن الله يؤاخذ به، والأمر بخلاف ذلك.
ولكن الظاهر لنا من الآية الشريفة هو أن معناها: أن ما في أنفسنا من السوء سواء ابدي أو أخفي مما يحاسب الله به فله تعالى أن يغفر لمن يشاء فضلا ويعذب من يشاء عدلا.
ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الأخبار الكثيرة من المؤاخذة على النية، وهي كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال:
1- ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله13. والحديث دال على أن الكافر يؤخذ بنيته أشد مما يؤخذ بعمله.
2- ما رواه أيضا عن أبي هاشم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا…الخ14.
ورواه مثله البرقي في المحاسن والصدوق في العلل.
وفي قبال هذه الأخبار أخبار دالة على العفو عن النية مطلقا أو عن النية إذا كانت من المؤمن فقط، فمن ذلك:
1- ما رواه الحر العاملي عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته: أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه، ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة15.
2- ما رواه أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المؤمن ليهم بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة، وإن هو عملها كتبت له عشر حسنات، وإن المؤمن ليهم بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه16.
فالأخبار متعارضة كما ترى، فلابد من الجمع بينها، وقد تعرض علماء الأصول في مبحث التجري إلى طرق الجمع بينها، فراجع.
ولكن لا تفوتنا هنا الإشارة إلى شئ وهو: أن المرتكز في أذهان المسلمين جميعا – حتى صغارهم ونسائهم – هو أن النية لا يؤاخذ أحد بها، وهو يؤيد القول بالعفو.
وتكون النتيجة بعد كل ذلك هي: أنه ليس المراد من قوله “أو تخفوه” ما يعرض للأنفس من الخواطر القهرية الخارجة عن الاختيار والوسع، حتى ينسخ بقوله ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾17 بل المراد منه هي النية التي هي مقدورة واختيارية، وهي معفو عنها من المؤمن.
قول تعالى ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾18.
قال في الإتقان: قيل: إنها منسوخة، وقيل: لا، ولكن تهاون الناس في العمل بها. وقال العتائقي: نسخها ﴿وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾19.
وقال الزرقاني كذلك، ثم قال: وقيل: إنها غير منسوخة، لأنها تدل على توريث مولى الموالاة، وتوريثهم باق، غير أن رتبتهم في الإرث بعد رتبة ذوي الأرحام، وبذلك يقول فقهاء العراق20.
والذي يمكننا القول به هنا هو أن قوله تعالى “وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ” كغيره من الآيات القرآنية يدل إجمالا على وجوب إيتاء النصيب لمن كان بينه وبين الميت عقد يمين، ولكن ما هو هذا النصيب؟ وضمن أي شروط؟ الجواب: غير معلوم.
فلو قلنا: إن الآية تفيد وجوب إيتاء النصيب لمن كان له ولاية بعقد اليمين الثابتة في الشريعة بنحو من الأنحاء الثلاثة لكانت الآية محكمة غير منسوخة.
والأنحاء الثلاثة لعقد اليمين هي إجمالا مع بيان الدليل
1- الموالاة بالعتق.
2- ولاء ضمان الجريرة.
3- الولاء بالنبوة والإمامة.
وتفصيل ذلك هو: أما الولاء بالعتق – بمعنى أن من أعتق عبدا فله ولاؤه الموجب لإرثه، إذا لم يكن له وارث من أرحامه – فهذا ثابت في الإسلام، وقد نقل الإجماع عليه21.
وتدل عليه أخبار كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال
1- ما رواه الفيض الكاشاني عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق22.
والحديث مذكور في كتب السنة والشيعة على حد سواء، قال ابن رشد بعد قوله ” الولاء لمن أعتق “: لما ثبت من قوله صلى الله عليه وآله في حديث بريرة: الولاء لمن أعتق23.
2- ما رواه الفيض أيضا عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا، لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه، إلا أن يكون له وارث غيرها24.
وللمسألة فروع كثيرة مذكورة في كتب الفقه، فمن أراد التوسعة فليراجع.
وأما ولاء ضمان الجريرة فقد قال الشيخ صاحب الجواهر: إنه لا خلاف نصا وفتوى في مشروعيته بالإجماع بقسميه على أن من توالى وركن إلى أحد يرضاه فاتخذه وليا يعقله ويضمن حدثه ويكون ولاؤه له صح ذلك، ويثبت به الميراث، بل كان الميراث في الجاهلية وصدر الإسلام بذلك25.
وتدل عليه أخبار كثيرة: منها: ما رواه الفيض الكاشاني عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة التي فرضها عليه مولاه، لمن يكون ولاء العتق؟ قال: يذهب فيوالي من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق؟ قال: هذا سائبة، لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حرا. ثم قال في بيان الوافي: العقل الدية، والسائبة: العبد الذي يعتق على أن لا ولاء له26.
ويستفاد من الحديث أن هذا المعتق لو كان حرا لكان وارثا، ولكن الرق هو المانع من إرثه هنا، وفي غيره من موارد الإرث.
ومنها: ما رواه أيضا عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له27.
فتحصل لدينا: أن عقد ضمان الجريرة يستلزم الإرث مع فقد الوارث النسبي والمعتق، والمسألة محررة في الفقه، فراجع.
وأما الإرث بولاء النبوة والإمامة فقد نقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا وارث من لا وارث له28.
وقال في جواهر الكلام: وإذا عدم الضامن كان ميراثا للإمام، نصا وإجماعا بقسميه29.
وتدل عليه أخبار كثيرة، نذكر منها
1- ما رواه الفيض الكاشاني عن عمار بن أبي الأحوص عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له30.
2- ما رواه أيضا عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء، وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه، قلنا له: فإن سكت حتى يموت ولم يتوال؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين31.
ويستفاد من الحديث: أن مال من لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين، فيحمل على الحديث السابق الذي يقول إن المال للنبي صلى الله عليه وآله أو للإمام بعده، ولكن لا على أنه ملك شخصي له يتصرف فيه كما يريد، بل على أنه له بما هو نبي وبما أنه إمام، فهو في الحقيقة من شؤون المنصب، ومن أجله فلابد وأن يجعل في بيت مال المسلمين، ليصرفه النبي أو الإمام في صلاح الإسلام والمسلمين.
فالتوريث بعقد الإيمان في الإسلام – كما هو الظاهر – يكون بأحد الأنحاء الثلاثة المتقدمة. فإذا كان المراد بقوله ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ هو هؤلاء الموالي الثلاثة، فالآية تكون محكمة غير منسوخة، وإذا كان المراد من الآية معان أخرى فلابد من طرحها حتى نتأمل فيها لنحكم فيها بالنسخ أو بالإحكام.
قوله تعالى ﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾32.
قال في الإتقان: إنها منسوخة بآية النور ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾33.
وقال العتائقي – بعد ذكر الآية: – قال عليه السلام: “لهن سبيل الثيب بالثيب الرجم، والبكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام” فالآية منسوخة بالسنة.
وقال السيد عبد الله شبر في تفسيره – بعد ذكره للآية -: كان ذلك عقوبتهن في أول الإسلام، فنسخ بالحد.
وكذا قال الشيخ الطبرسي في تفسير مجمع البيان.
وفي تفسير النعماني عن علي عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بالرأفة والرحمة، فكان من رأفته ورحمته أنه لم ينقل قومه في أول نبوته عن عاداتهم، حتى استحكم الإسلام في قلوبهم، وحلت الشريعة في صدورهم، فكان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت، وأقيم بأودها حتى يأتيها الموت. وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه، ولم يكونوا يعرفون غير هذا. قال الله تعالى في أول الإسلام ﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً * وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾34.
فلما كثر المسلمون وقوي الإسلام واستوحشوا الأمور الجاهلية أنزل الله ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ إلى آخر الآية، فنسخت هذه الآية آية الحبس والأذى35.
وقال الجصاص – بعد ذكر الآية -: لم يختلف السلف في أن ذلك كان حد الزانية في الإسلام، وأنه منسوخ36.
وقال الزرقاني – بعد أن ذكر أن الآية منسوخة بآية النور -: وذلك بالنسبة إلى البكر رجلا كان أو امرأة، أما الثيب من الجنسين فقد نسخ الحكم الأول بالنسبة إليهما، وابدل بالرجم الذي دلت عليه تلك الآية المنسوخة التلاوة، وهي “الشيخ والشيخة فارجموهما البتة”. وقد دلت عليه السنة أيضا37.
ونجد في قبال هؤلاء من قال بأن الآية غير منسوخة، إما لأن الحكم وهو الحبس لم يكن مؤبدا بل كان مغيى بغاية، وفقدان الحكم لحصول الغاية ليس نسخا، كما لو قيل: أحبس فلانا إلى الظهر، فجاء الظهر38.
وإما لعدم التنافي بين الآيتين، فإن الحكم الأول وهو الحبس شرع للتحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة أخرى، والحكم الثاني وهو الحد شرع للتأديب على الجريمة الأولى وصونا لباقي النساء عن ارتكاب مثلها، فلا تنافي بين الحكمين، لينسخ الأول بالثاني. نعم، إذا ماتت المرأة بالرجم أو الجلد ارتفع وجوب الإمساك في البيت لحصول غايته، وفيما سوى ذلك فالحكم باق ما لم يجعل الله لها سبيلا39.
والذي يبدو لنا من ظاهر الآية هو أن المراد من قوله تعالى “الفاحشة” بحسب ما هو ظاهر لفظها – بقطع النظر عن الأخبار الواردة في تفسيرها – أنها ما تزايد قبحه وتفاحش، كما نص عليه في بعض المعاجم40، وهذا أمر عام يشمل كل ما تمارسه النساء الفواسق من منكرات، مثل المساحقة والزنا. فالآية مع عمومها وشمولها للمساحقة غير منسوخة بما دل على حد الزنا المخصوص به. نعم، يحتمل النسخ في حد الزنا فقط، لو قلنا بأن الحبس كان في بدء الإسلام حدا، ثم نسخ بالجلد. هذا لو نظرنا إلى الآية مع قطع النظر عن الروايات الواردة فيها.
وأما إذا توجهنا إلى الروايات المفسرة للآية ولا محيص لنا عن الأخذ بها – فإننا نرى أن تلك الروايات قد فسرت الفاحشة بالزنا، واعتبرت الإمساك أنه الحد، ونذكر على سبيل المثال:
1- ما رواه السيد هاشم البحراني بسنده عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كل سورة النور نزلت بعد سورة النساء، وتصديق ذلك: أن الله عز وجل أنزل عليه في سورة النساء ﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ…الخ﴾ أما السبيل فقد ذكره تعالى في قوله ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا﴾41.
2- ما رواه العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله ﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ...الخ﴾ قال: هذه منسوخة.
قال: قلت: كيف كانت؟ قال عليه السلام: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود ادخلت بيتا، ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس، وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت، قلت: فقوله: “أو يجعل الله لهن سبيلا“؟ قال: جعل السبيل الجلد والرجم والإمساك في البيوت42.
3- ما رواه أيضا عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله ﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ – إلى: -سَبِيلاً﴾ قال: منسوخة، والسبيل هو الحدود43.
4- ما رواه السيوطي عن مسلم: أنه لما بين الحد قال صلى الله عليه وآله: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا44.
5- وعن ابن عباس قال: السبيل الذي جعله لهن: الجلد والرجم45. وكذا قال ابن رشد، ونسبه إلى الحديث الوارد.
وبعد هذا، فلا مجال للتشكيك فيما يراد من “الفاحشة”، إذ قد ثبت أن المراد بها هو الزنا، وكان الحد عليه في بدء الإسلام هو الحبس في البيوت، ضمن شروط معينة، مثل عدم التكلم معها ولا مجالستها، ثم نسخ الحكم بالجلد والرجم، وكان ذلك سبيلا لهن.
ولا ينبغي الإيراد على ذلك بأنه كيف يكون الرجم سبيلا لهن؟ وأنه إذا كان ذلك سبيلا لهن فماذا يكون السبيل عليهن؟
إذ قد رأينا أن الروايات قد فسرت السبيل بما ذكرنا من الجلد والرجم، ووقع التعبير به في كلمات العلماء. مع أن الرجم ا لمؤدي إلى قتل الزاني والزانية ربما يكون أسهل على غالب الناس من الحبس المؤبد، دون أن يتكلم معها أو يجالسها أحد، وكذا هو أسهل من نفي الزاني من مجالسهم وشتمه وتعييره.
قوله تعالى ﴿يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾46.
قال في الإتقان: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ منسوخ بقوله ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾47.
وقال الزرقاني – بعد ذكر الآية -: إنها منسوخة بقوله ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ ثم قال: وقيل: إنه لا نسخ48.
وعن زيد بن أسلم ومالك والشافعي وأبي حنيفة: أنها منسوخة، وأنه لا يجوز شهادة كافر بحال49.
ونجد في قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ، وأن الحكم الذي تضمنته الآية مستمر إلى الآن، لكنهم خصوه بالسفر، وبما إذا لم يكن مسلم يوصى إليه، وهو مذهب الإمامية بأجمعهم، كما وأن السيد شبر قال في قوله تعالى ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾: من أهل الذمة، ولا تسمع شهادتهم إلا في هذه القضية.
وقال الإمام الخوئي في كتابه “البيان”: إن الآية محكمة، وذهب إليه الشيعة الإمامية، وإليه ذهب جمع من الصحابة.
وفي تفسير النعماني لم يعد هذه الآية من المنسوخات المنقولة عن علي.
والذي يظهر لنا أن الآية حيث وقعت في سورة المائدة – وهي آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله – فإنها وكذلك سائر آيات سورة المائدة لم تتعرض للنسخ بما ورد في غيرها من السور، ويدل على ذلك ما رواه العياشي:
1- عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: نزلت المائدة قبل أن يقبض النبي صلى الله عليه وآله بشهرين أو ثلاثة50.
2- وعن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام، قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضا، وإنما كان يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بآخره، فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة، فنسخت ما قبلها، ولم ينسخها شئ51.
وروى أبو بكر الجصاص عن ضمرة بن جندب وعطية بن قيس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المائدة من آخر القرآن نزولا، فأحلوا حلالها، وحرموا حرامها52.
وعن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: في المائدة ثماني عشرة فريضة، وليس فيها منسوخ53.
هذا بالإضافة إلى ما ورد في أخبار الفريقين في تفسير الآية الكاشف عن بقاء الحكم واستمراره وإن كانت هذه الأخبار مختلفة المضمون، ففي بعضها: قال عليه السلام: قوله ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ هما كافران.
وفي بعضها الآخر: هما من أهل الكتاب.
وفي بعض ثالث: فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب54.
وغير ذلك من القيود الواردة في كتب التفسير، ونحن نذكر بعضها شرحا للقصة التي كانت سببا لنزول الآية على ما قالوا.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن رجاله رفعه قال: خرج تميم الداري وابن بيدي وابن أبي مارية في سفر، وكان تميم الداري مسلما، وابن بيدي وابن أبي مارية نصرانيين، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع، فاعتل تميم الداري علة شديدة، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيدي وابن أبي مارية، وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته، فقدما المدينة، وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته، فافتقد القوم الآنية والقلادة، فقال أهل تميم لهما: هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقالا: لا، ما مرض إلا أياما قلائل، قالوا: فهل سرق منه شئ في سفره؟ قالا: لا، قالوا: فهل أتجر تجارة خسر فيها؟ قالا: لا، قالوا: فقد افتقدنا أفضل شئ، كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجواهر وقلادة، فقالا: ما دفع إلينا فقد أديناه إليكم، فقدموهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأوجب رسول الله صلى الله عليه وآله اليمين، فحلفا، فخلى عنهما.
ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله، قد ظهر على ابن بيدي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما، فانتظر رسول الله صلى الله عليه وآله من الله عز وجل الحكم في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى “يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ” الآية. فأطلق الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر، ولم يجد المسلمين55.
وروى علي بن إبراهيم بسند صحيح عن يحيى بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين، فيقومان مقام الشاهدين الأولين…الحديث56.
ثم إن قبول شهادة الكافر في الوصية مما لا خلاف فيه في الجملة. فقد قال المحقق الحلي: تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية، إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها، ولا يشترط كون الموصي في غربة، وبالاشتراط رواية مطرحة.
وقال شارح المختصر النافع: إن أصل الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع57.
ثم لا يخفى أن الآية الشريفة تدل بإطلاقها على قبول شهادة الكافر بجميع أصنافه في الوصية. فمن خص الحكم بشهادة الذمي إذا كان مرضيا في دينه فإنما استند إلى الروايات الواردة في تفسير الآيات، المقيدة بما ذكر، وهذا من موارد تقييد الكتاب بالسنة.
وكذا من قال بقبول شهادة الذمي مطلقا ولو لم يكن في الغربة فإنما استند إلى عموم العلة الواردة في الأخبار. قال في الرياض في وجه عدم اشتراط الغربة: إنه لاحتمال ورود الحصر والشرط مورد الغالب فلا عبرة بمفهومها مع إطلاق كثير من النصوص58.
بل العموم يستفاد من التعليل الوارد في بعض الروايات، وهو قوله عليه السلام: ” لا يصلح ذهاب حق أحد ” والحكم يتبع العلة في التعميم والتخصيص، كما هو محرر في محله.
وأما أهل السنة فقد اختلفوا، فعن أبي حنيفة: أنه يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله. وعن مالك والشافعي: أنه لا يجوز ذلك، ورأوا أن الآية منسوخة. والنتيجة بعد كل ما قدمناه هي: أن القول بالنسخ لا يساعد عليه الدليل، وما دل على اعتبار الإسلام في الشهادة عام يخصص بما ورد في حجية قول الكافر في مورد خاص، لا أنه ينسخ به.
قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ﴾59.
قال في الإتقان: إنها منسوخة بالآية بعدها ﴿الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾60.
وقال في تفسير الجلالين – في تفسير الآية الأولى -: ثم نسخ لما كثروا بقوله ﴿الآنَ…الخ﴾.
وقال العتائقي – بعد ذكر الآية -: نسخ ذلك بقوله ﴿الآنَ…الخ﴾.
وقال الزرقاني: إنها منسوخة بقوله سبحانه ﴿الآنَ...الخ﴾. ووجه النسخ: أن الآية الأولى أفادت وجوب ثبات الواحد للعشرة، وأن الثانية أفادت وجوب ثبات الواحد للاثنين، وهما حكمان متعارضان، فتكون الثانية ناسخة للأولى.
وفي تفسير النعماني عن علي عليه السلام: إن الله تعالى فرض القتال على الأمة، فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين، فقال: ﴿فَإِن يَكُن مِّنكُم…الخ﴾، ثم نسخها سبحانه فقال: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن...﴾ الآية، فنسخ بهذه الآية ما قبلها، فصار من فرض المؤمنين في الحرب، إذا كانت عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا من الزحف.
وقال الطبرسي في تفسير مجمع البيان في معنى الآية: والمعتبر في الناسخ والمنسوخ بالنزول دون التلاوة.
وقال الحسن: إن التغليظ على أهل بدر، ثم جاءت الرخصة.
ونجد في قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ، وقد حكاه الزرقاني بقوله: لا تعارض بين الآيتين ولا نسخ، لأن الثانية لم ترفع الحكم الأول، بل هي مخففة على معنى أن المجاهد إن قدر على قتال العشرة فله الخيار رخصة من الله له بعد أن اغتر المسلمون، وقد كان واجبا تعيينيا.
وقال الإمام الخوئي: والحق أنه لا نسخ في حكم الآية. وقال في وجهه ما حاصله: إن النسخ يتوقف على إثبات الفصل بين الآيتين نزولا، وإثبات أن الآية الثانية نزلت بعد مجئ زمان العمل بالأولى، ولا يستطيع القائل بالنسخ إثبات ذلك، هذا بالإضافة إلى أن سياق الآيتين أصدق شاهد على أنهما نزلتا مرة واحدة. ونتيجة ذلك: أن حكم مقاتلة العشرين للمائتين استحبابي، ومن الممتنع أن يقال: إن الضعف طرأ على المؤمنين بعد قوتهم، فإنه خلاف الواقع، فإن المسلمين صاروا أقوياء يوما فيوما61.
كانت تلك بعض الكلمات حول الآية. والذي يظهر لنا هو أن الآية منسوخة بقوله تعالى ﴿الآنَ…﴾ الآية. وبيان ذلك: أن المستفاد من الآية هو أنه يجب على النبي تحريض المؤمنين على القتال، وترغيبهم في الجهاد، بذكر الثواب عليه، وذكر ما وعدهم الله من الظفر، وغير ذلك مما يشجع المؤمن على الجهاد. كما ويستفاد منها أنه يجب على المؤمنين قتال الكفار إذا كان عددهم عشر عدد الكفار، وأن عليهم أن يثبتوا في الحرب ولا يفروا، ثم خفف الله تعالى عليهم، فأوجب عليهم القتال إذا كان عدد الكفار ضعف عدد المؤمنين، فلو زاد الكفار على ذلك لم يجب على المؤمنين المقاومة ويجوز الفرار.
ثم إن قوله تعالى ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ…الخ﴾ خبر معناه الأمر بمقاومة الواحد للعشرة، ووعدهم بالغلبة إن صبروا، ثم خفف عنهم فأمرهم بمقاومة الواحد للاثنين.
ومما يدل على إرادة الأمر من الجملة الخبرية قوله تعالى: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُم﴾ فإن التخفيف لا يكون إلا بعد التكليف.
وبعد هذا، فإذا كان التكليف الثاني يغاير الأول ويباينه باعتبار أن الأول أشد من الثاني وأصعب منه فلابد من القول بالنسخ. ويؤيد هذا عدد من الأحاديث، منها: ما تقدم في تفسير النعماني عن علي عليه السلام. ومنها: ما عن شيخ الطائفة في التهذيب فقد روى بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يقول: من فر من الرجلين في القتال من الزحف فقد فر، ومن فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر62. ومنها: ما روي في الدر المنثور بطرق عديدة عن ابن عباس وغيره مما يقرب من المعنى المذكور.
وأما الإشكال على النسخ بأن الضعف لا يمكن أن يحدث في المسلمين بعدما كانوا أقوياء بل كانت قوتهم تزداد يوما فيوما فقد أجيب عنه بأن المراد من الضعف ليس ضعف العدة والعدة، بل المراد ضعف البصيرة واليقين، الذي يحدث حين يكثر المسلمون، ويختلط فيهم من هو أضعف يقينا وبصيرة.
وقال بعض المفسرين هنا – ولنعم ما قال -: وقد أثبتت التجربة القطعية أن المجتمعات المؤتلفة لغرض هام كلما قلت أفرادها وقويت رقباؤها ومزاحموها وأحاطت بها المحن والفتن كانت أكثر نشاطا للعمل وأحد في الأثر.
وكلما كثرت أفرادها وقلت مزاحماتها والموانع الحائلة بينها وبين مقاصدها ومطالبها كانت أكثر خمودا وأقل تيقظا وأسفه حلما63.
وعلى هذا، فنحن نقول: إن الآية ناسخة للأولى، وإنها نزلت بعدها وإن كانت حسب الترتيب القرآني متصلة بالأولى، والناسخ يشترط أن يكون متأخرا في الزمان لا في ترتيب الكتاب.
بقي شئ تحسن الإشارة إليه في المقام وهو: أن هذه النسبة – أي نسبة الواحد إلى اثنين – إنما تكون مؤثرة فيما لو كانت في ضمن الكثرة والفئة، كما يشعر به قوله تعالى ﴿فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْن﴾.
وعلى هذا، فلو انفرد اثنان من الكفار بواحد من المسلمين من دون وجود فئة وكثرة فيمكن القول بعدم وجوب الجهاد والثبات على الواحد، كما عن الشيخ في المبسوط والخلاف، والعلامة في القواعد64.
قوله تعالى ﴿انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾65.
قال في الإتقان: إنها منسوخة بآيات العذر، وهي قوله ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾66، وقوله ﴿لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء﴾ الآيتين67، وقوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً﴾68.
وقال العتائقي: نسخ ذلك بقوله ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً﴾ الآية، وبقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا﴾69.
وقال الشيخ الزرقاني: إنها نسخت بآيات العذر.
وعن ابن عباس والحسن وعكرمة أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ﴾70.
ونجد في قبال هؤلاء من قال بعدم النسخ.
ومنهم الإمام الخوئي، حيث قال في جملة كلام له: إن قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً﴾ بنفسه دليل على عدم النسخ، فإنه دل على أن النفر لم يكن واجبا على جميع المسلمين من بداية الأمر فكيف يكون ناسخا للآية المذكورة؟ وفي تفسير النعماني لم يعد هذه الآية في جملة ما نقله عن علي من الآيات المنسوخة.
والذي يظهر لنا هو: لا بآيات العذر، ولا بآية النفر كافة، ولا بآية الحذر.
أما أنها غير منسوخة بآيات العذر فلأن قوله تعالى ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ وإن كان ينافي إطلاق قوله تعالى “انفروا” لكن هذه المنافاة لا توجب المعارضة والمباينة ليكون اللاحق ناسخا للسابق، بل الذي تعارف العمل به عند كل أحد هو حمل المطلق على المقيد، والقول بأن موضوع المطلق ليس هو كل إنسان، بل موضوعه كل إنسان غير مريض وغير أعرج وغير أعمى.
ولا يخفى أن تخصيص العام وتقييد المطلق أمر شائع ومعروف، حتى قيل: ما من عام إلا وقد خص، وهذا بخلاف النسخ الذي هو نادر جدا في الشريعة، فلا يصار إليه إلا بعد عدم وجود غيره من وجوه الجمع، من التخصيص والتقييد.
وأما أنها غير منسوخة بقوله تعالى ?وما كان المؤمنون لينفروا كافة? بعدم تسليم العموم في قوله “انفروا” ولم نقل إنه خاص بمن أمر فاثاقل، كما في قوله تعالى: ?ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم?71 – لو سلمنا هذا – فإننا نقول: إنه إذا تعارض العام وهو جميع المسلمين، والخاص وهو بعضهم، فطريق الجمع بينهما هو أن يحمل العام على الخاص، لشيوع التخصيص، خصوصا من المقننين الذين يصدرون عادة أحكاما عامة أو مطلقة أولا، ثم يخصصونها أو يقيدونها.
هذا بالإضافة إلى ما سبق من بعض المحققين من أن ظاهر قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ…الخ﴾ هو أن النفر لم يكن واجبا على جميع المسلمين من بداية الأمر.
هذا كله على فرض التسليم بأن المراد بالنفر هو الخروج إلى الجهاد، وأما إذا كان المراد منه النفر إلى النبي صلى الله عليه وآله وتشرفهم بلقائه صلى الله عليه وآله ليستفيدوا ويتفقهوا منه صلى الله عليه وآله فلا يكون للآية صلة بالجهاد، وتخرج عن موضوع البحث في النسخ.
ولعل ظهور الآية يعطي ذلك، لأن كلمة ” فلو لا ” التحضيضية لنفر طائفة منهم ظاهر في أنه يجب على هذه الطائفة منهم الخروج، ثم عين غاية خروجهم هذا بقوله “ليتفقهوا” ومن المعلوم أن النفر للتفقه لا يكون إلا إلى النبي لا إلى الجهاد، وتدل على هذا المعنى – الذي نرى أنه هو ظاهر الآية – أخبار كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال:
1- ما رواه الشيخ الكليني بسند صحيح عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: أين قول الله عز وجل ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾72 قال: هم في عذر ما داموا في الطلب، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم73.
2- ما رواه السيد هاشم البحراني عن عبد المؤمن الأنصاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قوما رووا: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اختلاف أمتي رحمة، فقال: صدقوا، فقلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب، قال: ليس حيث تذهب وذهبوا، إنما أراد قول الله تعالى ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ…الخ﴾، فأمرهم الله أن ينفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويختلفوا إليه، فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم، إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلاف في الدين، إنما الدين واحد74.
والنتيجة هي: أنه إذا كان المراد بالنفر النفر إلى النبي صلى الله عليه وآله – كما عن الجبائي وأبي عاصم – فلا تنسخ بها آيات الجهاد، وتكون الآية محكمة غير منسوخة.
قوله تعالى ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينن﴾75.
قال في الإتقان: قوله تعالى ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً …الخ﴾ منسوخ بقوله ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ﴾76.
وقال العتائقي: إن الآية نسخت بقوله ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾.
ثم قال: وفيه نظر.
وقال الزرقاني: إنها منسوخة بقوله ﴿وَأَنكِحُوا…الخ﴾ لأن الآية خبر بمعنى النهي77.
ونقل الجصاص عن سعيد بن المسيب أنها منسوخة بالآية بعدها، وكان يقال: هي من أيامى المسلمين78.
وفي قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ، فمنهم:
1- الإمام الخوئي، حيث قال في جملة كلام له: إن الآية غير منسوخة، فإن النسخ فيها يتوقف على أن يكون المراد من لفظ النكاح هو التزويج، ولا دليل يثبت ذلك. على أن ذلك يستلزم القول بإباحة نكاح المسلم الزاني المشركة، وبإباحة نكاح المشركة المسلمة الزانية، وهذا مناف لظاهر الكتاب العزيز، ولما ثبت من سيرة المسلمين. والظاهر أن المراد من النكاح الوطي…الخ79.
2- ما عن الضحاك وابن زيد وسعيد بن جبير وإحدى الروايتين عن ابن عباس، فيكون نظير قوله ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾ في أنه خرج مخرج الأغلب الأعم80.
وكيف كان، فإن البحث يقع في أمرين
الأول: في حرمة زواج الزاني من المؤمنات، وحرمة زواج الزانيات من المؤمنين. وإنما يتزوج الزاني الزانية وبالعكس.
الثاني: في جواز زواج المسلم من المشركة، والمسلمة من المشرك. أما الأول فقد يقال: إن الآية قد نسخت بقوله تعالى ?وأنكحوا الأيامى منكم? لعموم الأيامى للزاني والزانية، فيجوز إنكاحهما، لدخولهم في موضوع الأمر.
وأجيب بأن آية إنكاح الأيامى تعم الزناة وغيرهم، وتلك الآية خاصة بالزناة، والخاص لا ينسخ بالعام، بل يخصص العام به، كما هو مقرر في علم الأصول من تقدم التخصيص على النسخ، لكثرة التخصيص وقلة النسخ.
هذا بالإضافة إلى أن الأخبار قد دلت على بقاء الحكم وعدم النسخ، وأنه لا يجوز تزوج المرأة المعلنة بالزنا، وكذا الرجل المعلن به إلا أن تعرف توبتهما. غاية الأمر: أن الحكم قد قيد بما إذا كان الزاني والزانية معلنين، وبما إذا أقيم عليهما الحد، وهذا من تقييد الآية بالسنة، ولا مانع منه، ونذكر من تلك الأخبار على سبيل المثال:
1- ما رواه الشيخ الحر العاملي رحمه الله بسنده عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا، إلا بعد أن تعرف منهما التوبة81.
2- وما رواه أيضا عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً…الخ﴾ قال: هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا، قد شهروا بالزنا، وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا (منهم) لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة82.
هذا، ولكننا نجد مع ذلك أن بعض أصحابنا قد أفتى بجواز نكاح الزاني لغير الزانية، وبالعكس، ولكنه مكروه، ولعل حملهم الآية على الكراهة من أجل تلك النصوص الواردة الدالة على جواز نكاح الزانية. قال المحقق الحلي: من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها، وكذا لو كانت مشهورة بالزنا83.
وقال الشارح: والمعروف من مذهب الأصحاب جواز مناكحة الزاني على كراهة، فإنهم حكموا بكراهة تزويج الفاسق مطلقا، من غير فرق بين الزاني وغيره84.
وأما أهل السنة فجمهورهم يقول بجواز نكاح الزانية، ولكنه مذموم.
قال ابن رشد: واختلفوا في زواج الزانية، فأجاز هذا الجمهور، ومنعها قوم – إلى أن قال: – وإنما صار الجمهور على ذلك لحمل الآية على الذم لا على التحريم، لما جاء في الحديث: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله في زوجته: أنها لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: طلقها، فقال: إني أحبها.
فقال له: فأمسكها85.
وأما الثاني – وهو جواز نكاح المسلم المشركة والمسلمة المشرك – فإن قبلنا دلالة الآية عليه فإننا نقول: إن الناسخ تارة يكون هو قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾86.
وتارة يكون ناسخها هو قوله تعالى﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾87.
وعلى كلا التقديرين يكون النسخ على خلاف ما قرروه من تقديم التخصيص على النسخ، لأن نسبة الآيتين إلى الآية الأولى – التي في سورة النور – هي العموم والخصوص مطلقا، فلابد في الجمع بينهما من القول بالتخصيص الذي هو شائع، لا بالنسخ الذي هو نادر. اللهم إلا أن يكون ثمة قرينة تمنع من التخصيص وتحتم النسخ، كما لو كان العام مما يأبى عن التخصيص، فقوله تعالى ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ﴾ وإن كان عاما يشمل الزاني وغيره، والآية الأولى خاصة بالزاني، إلا أن ذلك العام شديد الظهور والنصوصية بحيث يأبى عن التخصيص، فلابد من القول بالنسخ88.
والذي يسهل الأمر هو إجماع المسلمين على أنه لا يجوز زواج المسلم الزاني للمشركة، وكذا زواج المسلمة الزانية للمشرك.
قال الشيخ الطبرسي بعد ذكر قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ﴾: هي عامة عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار.
وقال المحقق الحلي: لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا89.
وعلق الشارح على قوله “إجماعا” بقوله: من المسلمين كلهم كتابا وسنة90.
وقال ابن رشد: واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية91.
وبعد هذه الجولة فإن النتيجة تكون هي: أن دلالة الآية على جواز نكاح المشرك للمسلمة الزانية والمشركة للمسلم الزاني – لو سلمت – فهي منسوخة إما بالآيتين السابقتين، أو بالسنة النبوية التي يكشف عنها إجماع المسلمين.
قوله تعالى ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾92.
قال في الإتقان: إنها منسوخة بقوله تعالى ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾93.
وقال العتائقي: إن قوله ﴿لَا يَحِلُّ…الخ﴾ نسخ بقوله تعالى ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا…الخ﴾. وهي من أعجب المنسوخ، لأنها بعد الناسخة.
وقال الزرقاني: إنها منسوخة بقوله تعالى ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا…الخ﴾.
ثم قال: واعلم أن هذا النسخ لا يستقيم إلا على أن هذه الآية متأخرة في النزول عن الآية الأولى، وهي كذلك على ترتيب النزول، وإن كانت في المصحف متقدمة عن الأولى.
وقال الشيخ المقداد السيوري: إنها منسوخة بقوله تعالى ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا…الخ﴾ وهو فتوى أصحابنا94.
وفي قبال هؤلاء من قال بعدم النسخ، فإنهم إما صرحوا بعدم النسخ، أو فسروا الآية من دون إشارة إلى أنها منسوخة، أو أنهم نسبوا النسخ إلى “القيل” مما يدل على أنهم هم لا يقولون به، ونذكر من هؤلاء:
1- الشيخ الطبرسي، الذي قال في مجمع البيان، في تفسير آية: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ﴾ أي من بعد النساء اللواتي أحللناهن لك في قوله ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لك…الخ﴾ وهي ستة أجناس – إلى أن قال: – وله أن يجمع ما شاء من العدد، ولا يحل له غيرهن من النساء.
عن أبي بن كعب وعكرمة والضحاك.
ويلاحظ أنه رحمه الله قد رفع التنافي بين الآيتين بذلك حين فسر كلمة “من بعد” بأن المراد من بعد النساء اللواتي ذكرن قبل، وعلى هذا فلا يكون ثمة تناف بين الآيتين لتنسخ إحداهما الأخرى.
2- العلامة الطباطبائي، الذي قال: قوله ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء…الخ﴾ ظاهرها لو فرضت مستقلة في نفسها غير متصلة بما قبلها – إلى أن قال: – لكن لو فرضت متصلة بما قبلها وهو قوله ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا…الخ﴾ كان مدلولها تحريم ما عدا المعدودات، وهي الأصناف الستة التي تقدمت95.
والذي يبدو لنا هو أن الآية غير منسوخة، وأن قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا…الخ﴾ كما أنها متقدمة في المصحف كتابة كذلك هي متقدمة نزولا، إذ من البعيد جدا تقديم ما تأخر نزوله على آية تقدم نزولها في سورة واحدة، خصوصا إذا كان الآمر بوضع الآيات في مكانها هو النبي صلى الله عليه وآله.
ولبيان ذلك نقول: إن الله تبارك وتعالى قد أحل لنبيه أصنافا ستة من النساء ذكرها في آية: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا...الخ﴾ بالإضافة إلى ما ملكته يمينه.
ثم قال سبحانه ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْد﴾ أي بعد المذكورات، فما حرمه على رسوله هو زواج غير ما ذكر في الآية المشتملة على الأصناف الستة، وأما منهن فلا دليل يدل على انحصار الزواج منهن في عدد خاص، فيجوز له التزوج منهن أي عدد شاء، ولو كان فوق التسع.
نعم، لو قيل: إن معنى قوله تعالى ﴿مِن بَعْد﴾ أي من بعد أزواجك اللواتي عندك في زمان نزول الآية، وهن تسع نساء – كما هو معروف – للزم القول بعدم جواز ما زاد على التسع، وكانت التسع في حقه صلى الله عليه وآله كالأربع في حقنا، ولكن هذا القيل مخالف لظاهر الآية، كما لا يخفى على من تأمل فيها.
فمعنى الآيتين – والله أعلم -: أنه يجوز لك الزواج من النساء المذكورات في آية ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا…الخ﴾ أي عدد شئت.
وأما من غيرهن فلا يجوز لك ذلك حتى ولو كان استبدالا بأن يستبدل بعض الستة المذكورات في الآية بغيرهن من أصناف أخرى.
ويدل على ما ذكرنا بعض الروايات أيضا، ونذكر على سبيل المثال: ما رواه الشيخ الكليني بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قول الله عز وجل ?يا أيها النبي إنا أحللنا أزواجك? قلت: كم أحل الله له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ…الخ﴾؟ – إلى أن قال: – ولو كان الأمر كما يقولون، قد أحل لكم ما لم يحل له، إن أحدكم يستبدل كما أراد…الحديث96.
وثمة أخبار أخرى تفيد هذا المعنى لا مجال لذكرها، وقد صرح الإمام في بعضها بأن المراد من النساء الممنوعة على النبي صلى الله عليه وآله هي المحرمات المعدودة في سورة النساء، من الام والبنت وغيرهما من المحارم. لكن هذا كما ترى يصادم ظهور الآية لو كان المراد من هذه الأخبار ظاهرها. ولعلنا لم نستطع نحن إدراك ما يرومون عليهم السلام إليه، قال الفيض الكاشاني: إن هذه الأخبار كما ترى، رزقنا الله فهمها97.
وعن عائشة قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم98.
قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا﴾99.
وقوله تعالى: ﴿وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا﴾100.
قال العتائقي: إن الآيتين منسوختان بقوله تعالى ﴿بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾101.
وقال في الإتقان: إن قوله تعالى ﴿وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ﴾ قيل: إنه نسخ بآية السيف، وقيل بآية الغنيمة وقيل: محكم.
وكذا نقله الزرقاني في مناهله عن بعض، لكنه هو قد اختار الإحكام، لإمكان الجمع بينهما، بأن يدفع من الغنائم مثل مهور هذه الزوجات المرتدات اللاحقات بدار الحرب – يدفع إلى الكفار – ثم تخمس الغنائم أخماسا، وتصرف في مصارفها الشرعية.
وقال الجصاص في أحكام القرآن: إن هذه الأحكام في رد المهر، وأخذه من الكفار، منسوخ عند جماعة من أهل العلم، غير ثابت الحكم شيئا.
والذي يبدو لنا هو أن آيات سورة الممتحنة مشتملة على أحكام تعبدية إسلامية، لا ربط لها بالاتفاق الذي كان في صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وآله وأهل مكة، كما قيل من أنه إن لحق بالمسلمين رجل من أهل مكة ردوه إليهم، وإن لحق بأهل مكة رجل من المسلمين لم يردوه إلى المسلمين.
وهذه الأحكام التعبدية التي تدل عليها الآيتان هي
1- إذا هاجر إليكم نساء مؤمنات فامتحنوهن بإحلافهن على أنهن لم يخرجن إلا للإسلام، لا بغضا بزوج، ولا حبا بأحد، وحينئذ فلا يجوز ردهن إلى الكفار لقوله تعالى ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾102.
2- يجب على المسلمين أن يؤتوا الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور.
3- يجوز تزوج المسلمين بهن وإن كان لهن أزواج في بلاد الكفر، لأن الإسلام أوجب بينونتهن من أزواجهن، بشرط إعطائهن مهورا جديدة وعدم الاكتفاء بما أعطى أزواجهن الكفار.
4- إذا كان للمسلمين زوجات باقيات على الكفر فلا يقيمون على إنكاحهن، لأن الإسلام أبانهن منهم.
5 – يجوز للمسلمين أن يطلبوا من الكفار مهور نسائهم اللواتي يلحقن بالكفار.
6- ما ذكره الله تعالى بقوله ﴿وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ﴾ أي فاتتكم الزوجات أو فاتكم المهر بسببهن ﴿مِّنْ أَزْوَاجِكُم﴾ المهاجرات ﴿إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُم﴾ أي أصبتم عقبى، يعني غنيمة ﴿َآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا﴾ من المهر.
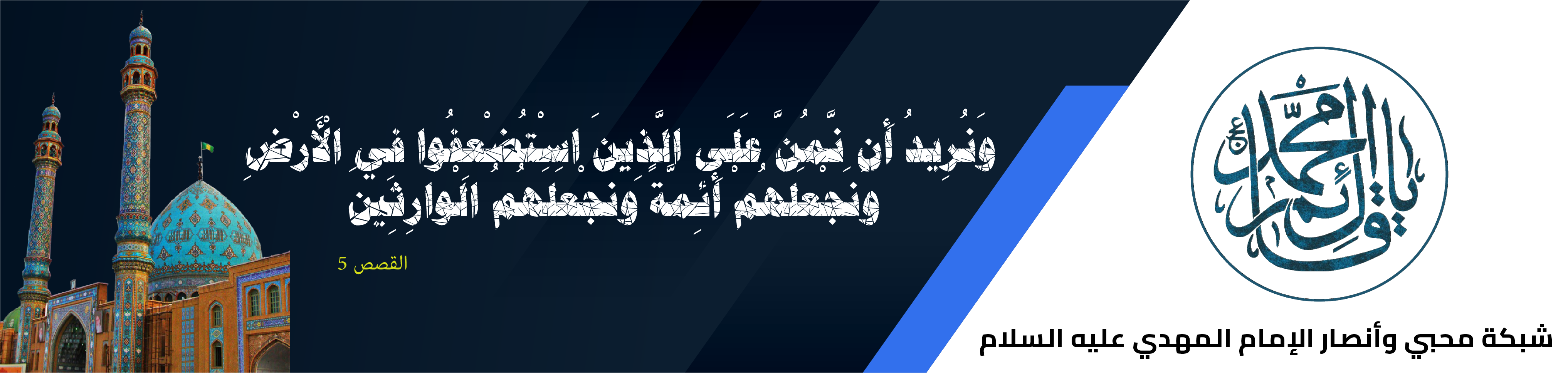 شبكة محبي وأنصار الإمام المهدي ع موقع اسلامي تربوي هادف منذ 1999
شبكة محبي وأنصار الإمام المهدي ع موقع اسلامي تربوي هادف منذ 1999